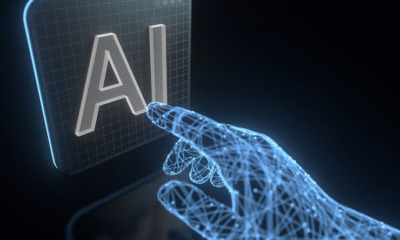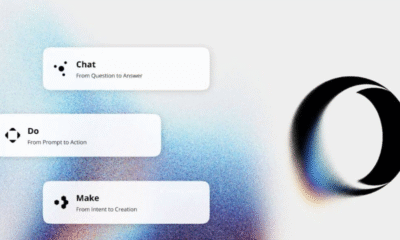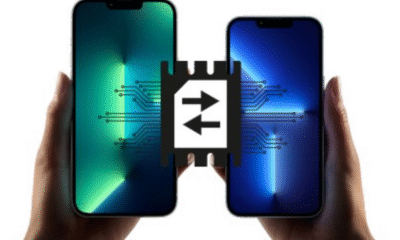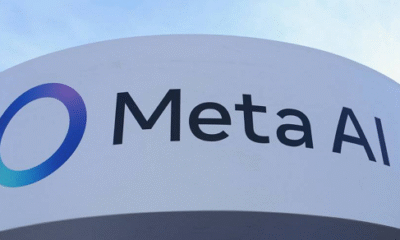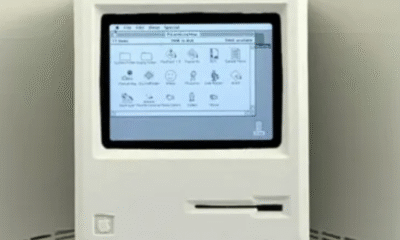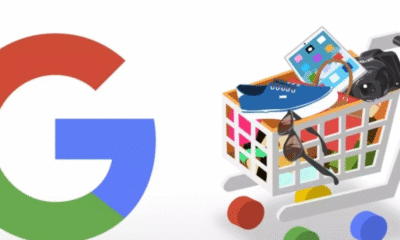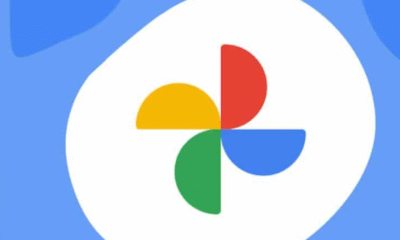الذكاء الاصطناعي
سباق الذكاء الاصطناعي في 2024 من يتصدر المشهد

الذكاء الاصطناعي
ميتا تُراهن على نظارات الواقع المختلط الخفيفة إطلاق مرتقب في 2026
الذكاء الاصطناعي
وكلاء الذكاء الاصطناعي مستقبل المؤسسات في الابتكار والتسويق
الذكاء الاصطناعي
مايكروسوفت تُطلق أداة مجانية لإنشاء فيديوهات بالذكاء الاصطناعي عبر Bing
-
تطبيقات وبرامج7 أيام ago
Opera تُعيد تعريف التصفح إطلاق متصفح Neon المدعوم بالذكاء الاصطناعي
-
أخبار الشركات7 أيام ago
آبل تمهّد لحقبة جديدة من التوافق تسهيل نقل eSIM من آيفون إلى أندرويد
-
أخبار تقنية6 أيام ago
مساعد Meta AI يتجاوز مليار مستخدم إنجاز تقني أم مبالغة تسويقية
-
أخبار الشركات7 أيام ago
ميتا تتجه إلى عالم المتاجر الفعلية خطوة جديدة لتعزيز حضورها في سوق الأجهزة الذكية
-
أجهزة محمولة7 أيام ago
تحفة تقنية بحجم راحة اليد إطلاق أصغر جهاز ماك في العالم بسعر رمزي
-
أخبار الشركات7 أيام ago
غوغل تُطلق متجرها الرسمي في الهند مزايا جديدة وتجربة تسوّق متكاملة
-
تطبيقات وبرامج7 أيام ago
تحديث ثوري لتطبيق صور جوجل محرر ذكي بواجهة جديدة وأدوات إبداعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي
-
الذكاء الاصطناعي7 أيام ago
شراكة الذكاء الاصطناعي Grok يدخل تيليجرام بصفقة مليارية بين ماسك ودوروف